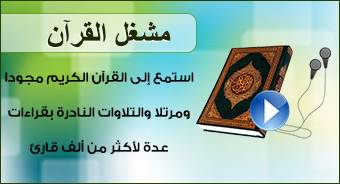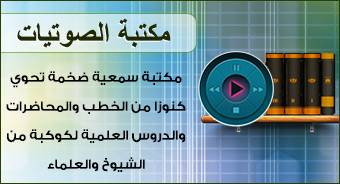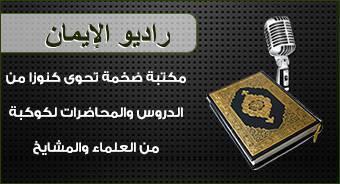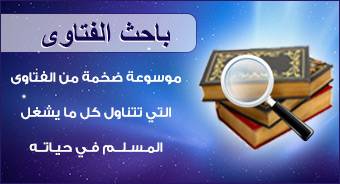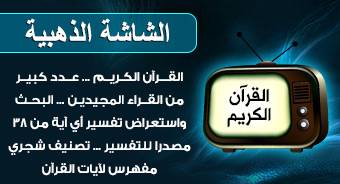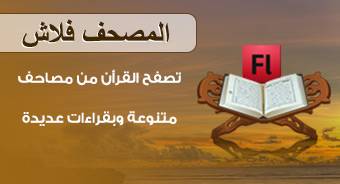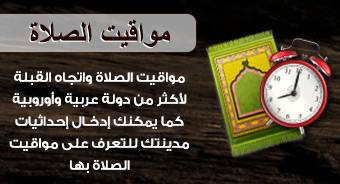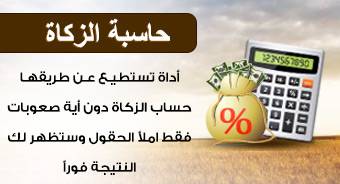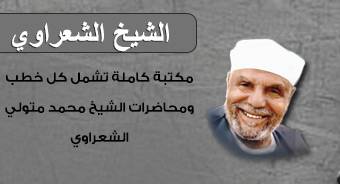|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
مثال ذلك إن ضاعت من أحدكم حافظة نقوده، وسارقها غيب، ومكانها غيب عن صاحبها، لكن الذي سرقها عارف بمكانها، إذن فهذا غيب على المسروق، ولكنه ليس غيبًا على السارق. لأنه ليس غيبًا مطلقًا، وهذا ما يضحك به الدجالون على السذج من الناس، فبعض من الدجالين والمشعوذين قد يتصلون بالشيطان أو الجن؛ ويقول للمسروق حكاية ما عن الشيء الذي سُرق منه هؤلاء المشعوذون لا يعرفون الغيب؛ لأن الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه أحد، فقد استأثر به الله لنفسه.ومثال آخر: الأشياء الابتكارية التي يكتشفها البشر في الكون، وكانت سرًا ولكن الله كشف لهم تلك الأشياء، وقد يتم اكتشافها على يد كفار أيضا. فهل قال أحدٌ: إنهم عرفوا غيبًا؟ لا؛ لأن لمثل هذا الغيب مقدمات، وهم بحثوا في أسرار الله، ووفقهم سبحانه أن يأخذوا بأسبابه ما داموا قد بذلوا جهدًا، والله يعطي الناس- مؤمنهم وكافرهم- أسبابه. وما داموا يأخذون بها فهو يعطيهم المكافأة على ذلك. ولله المثل الأعلى، وسبحانه منزه عن كل تشبيه، أقول لكم هذا المثل للتقريب:المدرس الذي يعطي تمرين هندسة للتلميذ ليقوم بحله، فهل مجيء الحل غيب.؟ لا؛ لأن التلميذ يعرف كيف يحل التمرين الهندسي؛ لأن فيه المعطيات التي يتدبر فيها بأسلوب معين فتعطى النتيجة. وما دام التلميذ يخرج بنتيجة لتمرين ما بعد معطيات أخذها، فذلك ليس غيبًا.ولذلك فعلينا أن نفطن إلى أن الغيب هو ما غاب عن الكل، وهذا ما استأثر الله بعلمه وهو الغيب المطلق، وهو سبحانه وتعالى يطلع عليه بعضًا من خلقه من الرسل، وهو سبحانه القائل: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ} [الجن: 26-27].وأما الأمر المخفي في الكون، وكان غيبًا على بعض من الخلق ثم يصبح مشهدًا لخلق آخرين فلا يقال أنه غيب، وعرفنا ذلك أثناء تناولنا بالخواطر لآية الكرسي: {اللَّهُ لا إله إلا هو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} [البقرة: 255].إن الحق سبحانه قد نسب هنا الإحاطة للبشر، ولكن بإذن منه، فهو يأذن للسر أن يولد، تمامًا كما يوجد للإنسان سلالات ولها أوقات معلومة لميلادها، كذلك أسرار الكون لها ميلاد.وكل سر في الكون له ميلاد، هذا الميلاد ساعة يأتي ميعاده فإنه يظهر، ويحيط به البشر. فإن كان العباد قد بحثوا عن السر وهم في طريق المقدمات ليصلوا اليه ووافق وصولهم ميعاد ميلاده، يكونوا هم المتكشفين له. وإن لم يحن ميعاد ميلاد هذا السر فلن يتم اكتشافه واذا حان ميلاد السر ولم يوجد عالم معملي يأخذ بالأسباب والمقدمات فالله يخرج هذا السر كمصادفة لواحد من البشر. وحينئذ يقال: إن هذا السر قد ولد مصادفة من غير موعد ولا توقع.وأسرار الله التي جاءت على أساسها الاكتشافات المعاصرة، كثير منها جاء مصادفة. فالعلماء يكونون بصدد شيء، ويعطيهم الله ميلاد سر آخر. إذن فليس كل اكتشاف ابنًا لبحث العلماء في مقدمات ما، ولكن العلماء يشتغلون من أجل هدف ما، فيعطيهم الله اكتشاف أسرار أخرى؛ لأن ميلاد تلك الأسرار قد جاء والناس لم يشتغلوا بها. ويتكرم الله على خلقه ويعطيهم هذه الأسرار من غير توقع ولا مقدمات.ويستمر سياق الآية: {فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ} وهو سبحانه يخاطب المؤمنين. والحق سبحانه وتعالى إذا خاطب قومًا بوصف، ثم طلب منهم هذا الوصف فما معناه؟. ومثال ذلك قول الحق سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ} [النساء: 136].إنهم مؤمنون، والحق قد ناداهم بهذا الوصف. معنى ذلك أنه يطلب منهم الالتزام بمواصفات الإيمان على مر الأزمأن لان الإيمان هو يقين بموضوعات الإيمان في ظرف زمني والأزمان متعاقبة لأن الزمن ظرف غير قارٍ. وغير قارٍ تعني أن الحاضر يصير ماضيًا، والحاضر كان مستقبلًا من قبل. فالماضي كان في البداية مستقبلًا، ثم صار حاضرًا، ثم صار ماضيًا. والزمن ظرف، ولكنه ظرف غير قار.. أي غير ثابت. لكن المكان ظرف ثابت قار. فكأن الله يخاطبك: إن الزمن الذي مر قبل أن أخاطبك شُغِل بإيمانك، والزمن الذي يجيء أيضا اشغله بالإيمان.إذن معنى ذلك: يا أيها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم. {وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ} ولنا أن نتصور عظمة عطاء الحق، فالمنهج الإيماني يعود خيره على من يؤديه، ومع ذلك فالله يعطي أجرًا لمن اتبع المنهج. إذن فعندما يضع الحق سبحانه وتعالى منهجًا فإنه قد فعله لصالح البشر وأيضا يثيبهم عليه، وهو يقول: {فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَى} [طه: 123-124].إن المتَّبع للمنهج يأخذ نفعه ساعة تأدية هذا المنهج. ويزيد الله فوق ذلك أنه سبحانه يعطي المتبع للمنهج أجرًا، وهذا محض الفضل، وقلنا من قبل: إن العمر الذي يمده الله للكافرين والمنافقين ليس خيرًا. إذن فعلى الناس أن يأخذوا المسائل والأزمنة بتبعات وآثار ونتائج ما يحدث فيها. اهـ.
كما تقدم تحقيقه ويذر فعل لا يتصرف- كَيَدَعُ- استغناء عنه بتصرُّف مرادفه- وحُذِفت الواو من يذر من غير موجب تصريفي، وإنما حُمِلَت على يدع لأنها بمعناها، ويدع حُذِفت منه الواوُ لموجب، وهو وقوع الواو بين ياءٍ وكسرةٍ مقدرة وأما الواو في يذر فوقعت بين ياء وفتحةٍ أصليةٍ. وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى: {وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الربا} [البقرة: 278].قوله: {حتى يَمِيزَ} حتى- هنا- قيل: هي الغائية المجرَّدة، بمعنى إلى والفعل بعدها منصوب بإضمار أن وقد تقدم تحقيقه في البقرة.فإن قيل الغاية- هنا- مشكلة- على ظاهر اللفظ- لأنه يصير المعنى: أنه تعالى لا يترك المؤمنين على ما أنتم عليه إلى هذه الغاية- وهي التمييز بين الخبيثِ والطَّيِّبِ- ومفهومه أنه إذا وُجِدَت الغاية ترك المؤمنين على ما أنتم عليه.هذا ظاهرُ ما قالوه من كونها للغاية، وليس المعنى على ذلك قَطْعًا، ويصيرُ هذا نظيرُ قولكَ: لا أكَلِّم زيدًا حتى يقدم عمرو، فالكلام منتفٍ إلى قدوم عمرو.فالجوابُ عنه: {حَتّى} غاية لمن يفهم من معنى هذا الكلام، ومعناه: أنه تعالى يخلص ما بينكم بالابتلاء والامتحان إلى أن يميز الخبيثَ من الطيبِ.وقرأ حمزة والكسائي- هنا وفي الأنفال- {يُمَيِّزَ} بالتشديد- والباقون بالتخفيف، وعن ابن كثيرٍ- أيضا- {يُميز} من أماز فهذه ثلاث لغاتٍ، يقال: مَازَه وميَّزه وأمازه. والتشديد والهمزة ليسا للنقل؛ لأنّ الفِعْلَ- قبلهما- مُتَعَد، وإنما فعّل- بالتشديد- وافعل بمعنى: المجرد. وهل ماز ومَيَّز بمعنًى واحدٍ، أو بمعنيين مختلفين؟ قولان. ثم القائلونَ بالفرق اختلفوا، فقال بعضهم: لا يقال: ماز، إلا في كثير، فأما واحدٌ من واحدٍ فميَّزت، ولذلك قال أبو مُعاذٍ: يقال ميَّزتُ بين الشيئين تَمْييزًا، ومِزْت بين الأشياء مَيْزًا.وقال بعضُهُمْ عكس هذا- مزت بين الشيئين مَيْزًا، وميَّزت بين الأشياء تمييزًا- وهذا هو القياس، فإنَّ التضعيفَ يؤذن بالتكثير، وهو لائقٌ بالمتعددات، وكذلك إذا جعلتَ الواحد شيئين قلت: فَرَقْت:- بالتخفيف- ومنه: فرق الشعر، وإن جعلته أشياء، قلت: فرَّقْتها تَفْرِيقًا.ورجَّح بعضُهم مَيَّز- بالتشديد- بأنه أكثر استعمالًا، ولذلك لم يستعملوا المصدر إلا منه، قالوا: التمييز، ولم يقولوا: المَيْز- يعني لم يقولوه سماعًا، وإلا فهو جائز قياسًا.قوله: {وَلكِنَّ} هذا استدراكٌ من معنى الكلامِ المتقدمِ؛ لأنه تعالى- لما قال: {وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ} أَوْهَمَ ذلك أنه لا يُطْلِعُ أحدًا على غيبه؛ لعموم الخطابِ- فاستدرك الرُّسُلَ. والمعنى: {وَلَكِنَّ الله يَجْتَبِي} أي يصطفي {مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ} فَيَطْلِعُهُ على الغيبِ، فهو ضِدٌّ لما قبله في المعنى، وقد تقدم أنها بين ضِدَّيْنِ ونقيضَيْن، وفي الخلافين خلافٌ.يَجْتَبِي: يصطفي ويختار، من: جَبَوْت المال والماء، وجبيتهما- لغتان- فالياء في يجتبي يُحْتَمَل أن تكون على أصلها، ويُحْتَمل أن تكون منقلبةً عن واوٍ؛ لانكسارِ ما قبلها.ومفعول يَشَاءُ محذوفٌ، وينبغي أن يقدر ما يليق بالمعنى، والتقدير: يشاءُ إطلاعه على الغيب. اهـ. بتصرف.
|